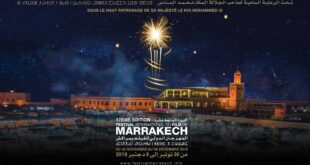عبد الواحد المهتاني
الكثير من الآثار المغربية غربت عن موطنها بالنهب والسرقة، تشكل ثروة حضارية يمتد زمانها إلى قبل التاريخ مرورا بالعهد الفينيقي والروماني والوندالي إلى المماليك الأمازيغية والإمبراطوريات التي حكمت المغرب خلال العصر الوسيط وما بعده … وأخرى لازالت منطوية في الظلمة ضمن حضاراتها التقليدية، المكومة تحت التراب.
ولكون الثقافة تحتل مراتب متأخرة ضمن الاهتمام الحكومي، وموقع هامشي على مستوى التعليم والسياحة والصناعة التقليدية بما تمثله من رموز وأشكال حضارية، فضلا عن التنمية بوجهها المادي وغير المادي، فإن الوزارة المعنية والجهات الوصية، لم تحص يوما الآثار المسروقة سنويا، ولا تكلف نفسها عناء تقديم برنامجها السنوي في مجال البحث الأثري، الموكول تدبيره عامة إلى علماء الآثار المغاربة اعتمادا على امكانياتهم الخاصة من خلال شراكات مع معاهد وجامعات أجنبية لتغطية جزء يسير من نفقات البحث، بل حتى ترميم الآثار وحمايتها لا تعنيها في شيء، باستثناء مبادرات معدودة على رؤوس الأصابع، تمت خلال بعض الحكومات المتعاقبة في تاريخ المغرب، أبرزها ما تم على عهد وزير الثقافة السابق محمد الأشعري.
وإذا كانت وزارة الثقافة، لا تقوم بجرد لوحات الفنون التشكيلية التي في حوزتها، وحتى إن قامت بذلك، بقي الأمر في طي الكتمان كما كان عليه الحال في عهد بن سالم حميش، الذي صرح لأحد جماعي اللوحات، أن الرصيد المتبقي، لا يتعدى رؤوس الأصابع، فكيف سيكون الحال بإزاء التحف الفنية المتواجدة ببعض المواقع الأثرية أو في المتاحف الوطنية، وكلنا يذكر المصير الغادر لمتحف المدينة العتيقة بمدينة البيضاء، الذي أسسه كل من ماجوريل وبراني مدير ليسي ليوطي في ذلك العهد، ومعمر الزاوي وهو من أصل جزائري وذلك منذ سنة 1919، وكانت به لوحات لماجوريل لا تقدر بثمن، التي يصل ثمنها اليوم إلى خمسة مليارات سنتيم. إلى جانب زراب وحلي، ولم تفلت منها إلا عظام الولي الصالح سيدي عبد الرحمان التي نقلت إلى متحف الرباط.

يقول مثل عربي مأثور: “من باع قديمه لا جديد له“
يردد حال لسان الوزارة على الدوام وهي تواجه كومة من الملفات في هذا الباب، العين بصيرة واليد قصيرة، لكن ما هو دور الوزير والمؤسسة التي يشرف عليها، هل هو فقط تصريف الوارد والمنصرف، على غرار حسابات البقالين، فهذا لا يحتاج إلى مديريات وأقسام ومصالح من مديرية الفنون إلى مديرية التراث، فأين نحن من مفهوم البرنامج الحكومي وقبله البرامج الحزبية إن وجدت؟ وما هي مؤهلات هذا الوزير أو ذاك لإدارة المنصب المسند إليه؟ وما هو مفهومه للشراكة والاستشارة مع الفاعلين في الحقل لأجل بلورة البرامج وإغنائها ووضع آليات تنفيذها وتوفير مواردها المالية واللوجستية من خلال ميزانية الدولة وباقي الشركاء العمومين أو الخواص، فكيف لمؤسسة على غرار متحف بنك المغرب بموظفين يعدون على رؤوس الأصابع أن تقوم بمبادرات يمتد إشعاعها إلى خارج البلاد فيما لا تستطيع وزارة بجيش من موظفيها أن تنظم تظاهرة محلية وأحرى وطنية تثير الانتباه؟
يكفي الوزير عدسات المصورين، وهلم تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، أما التواصل الفعلي فهو يكاد يكون شبه منعدم، تجسيدا لشعار وكم حاجة قضيناها بتركها، وإذا ما أحرج الوزير بمناسبة ما صرح سرا “الوزارة فقيرة”، وهو قول سديد، غير أن الفقر المدقع يكمن في الأفكار وفي تدبير شأن الثقافة، وتنشيط تظاهرات لها شأن، والدليل هو أن أغلب المركبات الثقافية التابعة لها لا تستطيع مجتمعة أن تنافس مركزا ثقافيا أجنبيا كالمركز الثقافي الفرنسي على سبيل الحصر، فكيف والحال هاته أن تدبر برامج ثقافة على مستوى المواقع الأثرية.
وعطفا عليه نطرح السؤال، ألا تتوفر على رصيد لا مادي غير مستنفذ يمكن أن يخلق الثروة؟
نسوق في هذا الباب، مداخيل موقع وليلي وقصر الباهية، فكليهما يدر لوحده على خزينة الدولة مليار سنتيم سنويا، لا يستفيد الموقعان منها من سنتيم واحد ولو على مستوى الصيانة والترميم وتحسين الخدمات، فأحرى التنشيط الثقافي، وبالمناسبة هناك حوالي 15 ألف موقع أثري تضم كنوزا لو تم استثمار طاقتها ضمن الحد الأدنى لوفرت معدل المليار سنتيم لكل واحد منها.

أعيدوا إلي ما صنعت يداي
فهل هذا يحتاج إلى مكتب دراسات ليقول لنا بأننا لا نعرف كيفية استثمار هاته الكنوز بالاستثمار في المحميات الأثرية الاستثنائية، بكيفية يكون لها الأثر العظيم على السياحة والصناعة التقليدية والساكنة المحلية، كدعمها “بالبنيات التحتية المستدامة حتى تصير فضاءات لنقل المعرفة والتكوين في علم الآثار”.
فلماذا لا نجعل من تمثال الرخام لإله الخمر” باخوس”، الذي نهب في جنح الظلام، بداية الثمانينيات، من موقع وليلي، على عهد مديرة التراث في ذلك الوقت، أيقونة على شكل مجسم صغير أو مسكوكة فضية أو نحاسية وحتى ذهبية اعتمادا على ما يحتفظ به من صور لباخوس، نقدمها بمقابل مادي محترم للمغاربة والسياح الأجانب، ونفس الأمر للعملة النقدية للملك الأمازيغي جوبا والتي يعود تاريخها إلى 40 سنة قبل الميلاد، بما أن بنك المغرب لازال يحتفظ بجذاذتها، إلى جانب صورة جوبا وثعبان، وهكذا مرورا بالعملة الشاكرية التي طافت جل أصقاع العالم ونماذج من النقوش الصخرية وغيرها من الأشكال الأثرية المتعددة الممكن ترويجاها في فضاءات المتاحف والبازارات، والمواقع التاريخية، وهنا يمكن الاستئناس بنماذج عدة لذلك في الجارة الشمالية من قادس إلى قرطبة، إلى غرناطة التي تستقطب لوحدها في الشهر الواحد ما لا تستقطبه مجمل المدن المغربية في السنة الواحدة.
وبما أن التاريخ أصبح يدرس في المتاحف والمواقع الأثرية أكثر من الفصول الدراسية، فما هو دور وزارة الثقافة في تنظيم شراكات مع وزارة التعليم لتنظيم زيارات موجهة بثمن رمزي، هدفه تقديم المعرفة للجيل الحالي وجعله يعتز بتراثه، وزبونا مستقبليا لفضاء المتحف والموقع الأثري.
وهل نحتاج إلى مكتب دراسات ليؤكد لنا على بديهيات، من قبيل تسريع الأبحاث في مواقع قد يطمسها الإسمنت المسلح على غرار جزء من تكاوست وكلميم القديمة والرباط وتامسنا ومراكش وغيرها من المدن التي غمرها الزحف العمراني. أما أطلال مدينة أتلانتس التاريخية المفقودة والتي تحدث عنها أفلاطون وقال بشأنها الخبير الإلكتروني الألماني مايكل هوبنر، بأنها موجودة في المغرب ببلاد سوس ماسة، وفق نظريته التي أكد عليه مارك آدمس، فاتركوا أمرها إلى أن يبادر عالم صالح ليجسد نظرية هوبنر.

من القتل المادي إلى الرمزي
ابتكار الوسائل والإجراءات المدعومة بأفكار وتصورات ناجعة وفعالة، يحتاج فقط إلى إرادة وروح إبداعية، لكن القصور والتقصير قتل ملحق بالقتل السابق، ومنه أيضا عدم القدرة على المتابعة لاسترداد التحف الوطنية المهربة والمغربة عن موطنها، والذي سيظل إشكالا معلقا في انتظار الذي يأتي ولا يأتي. فكل ما أنتجه الأسلاف من نماذج الابتكار والأشكال هي ملكية حضارية تبرهن على وجودنا على هاته الأرض وعلى إشعاعنا الروحي، لا يحتاج إلى تأكيد. الإشكال الأكبر أن ما تبقى الكثير منه معرض للنهب والتلف وفي أبسط الأحوال، التبول عليه في واضحة النهار من طرف الكبار والصغار، لأن المدرسة لم تساعدنا على تمثل الهوية الحضارية المغربية بألوانها المتعددة وتنمي فينا رهافة الإحساس بعبقرية الأسلاف وإبداعيتهم، ولأن إعلامنا المرئي كذلك لا زال أسيرا لمقاربات فلكلورية لا تساعد المواطنين على العثور في زوايا العالم ضمن بنيانه الجديد على أسلافهم وتحريرهم من كل سماتهم المشوهة، بل الأنكى من ذلك إضفاء المزيد من المسخ والتشويه على حضارتنا، تحت عناوين براقة كـ “من عبق التاريخ” الذي يقوم بتزييف معطيات فن العيش المغربي القديم، لأن القيمين على هاته البرامج إما هم مشتبكون بمصالح مع الجهات المنفذة لهاته الخردة من البرامج، أو كونهم جهلة، وربما الاثنان معا، وستكون لنا عودة للموضوع، حتى لا نتهم بإطلاق الكلام على عواهنه.

إعلام على درب الكلاوي
على سبيل الختم، نشير إلى بعض فرق أحواش حين كان يستدعيها القائد الكلاوي، لتقديم عروض في حضرة ضيوفه، بأن أعضاء هاته الفرق كانوا يوشوشون في آذان بعضهم، “السياحة”، في إحالة منهم على تقديم الفرجة خارج النمط التقليدي لقواعد أحواش، وهكذا ضاعت، إن لم نقل انقرضت مجموعة من الأشكال الفرجوية عن هذا الموروث الوطني، الأمر نفسه ينطبق على قطاع الصناعة التقليدية، ففي جولة قصيرة بأسواق الفضة بتزنيت، سيجد المتسوق نفسه أمام منتوجات تركية أكثر منها أمازيغية، لأن الصانع التقليدي أصبح مطوقا بإكراهات كلفة المادة الخام وبوار الصناعة المحلية، لأن “صنعة بلادي”، اختارت التسويق للفاعل الحكومي أكثر من المنتوج الوطني، واللهم لا حسد لهاته “الرؤى الثاقبة” التي تسيدت حقول الثقافة والسياحة والإعلام، تصول وتجول وتكسب المغانم، لا محاسبة شرعية، ولا أخلاقية، ولا ضمير، ومن سخرية هذا الزمن الرديء تؤكد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون على سبيل المثال في دفاتر تحملاتها، على “إبراز القيم الوطنية” في بعض برامجها كالدراما مثلا، وهي للأسف قائمة على “اللحلحة”، وترطيب الخواطر والدفع من تحت الطاولات، وتكريس ثقافة الريع. وللقائل بأن لا دليل لدينا فيما نذهب إليه، نوقر في أذنه انه يمكننا العودة إذا شاء إلى خردة هاته البرامج لتحليلها حسب الجنس والنوع والموضوع وزاوية المعالجة، إلى السوية الفنية والقيمة الإنتاجية الحقيقية، خارج منطق حساب دفاتر البقال.
 بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.